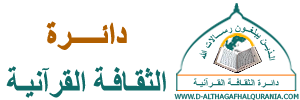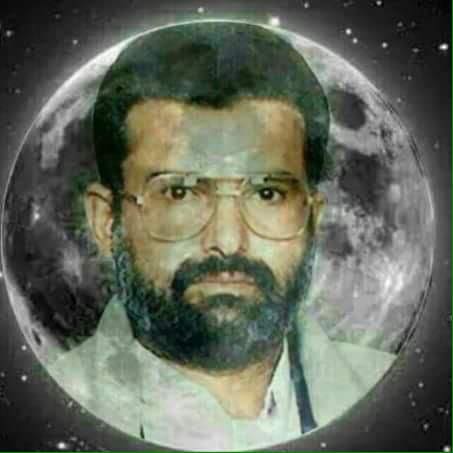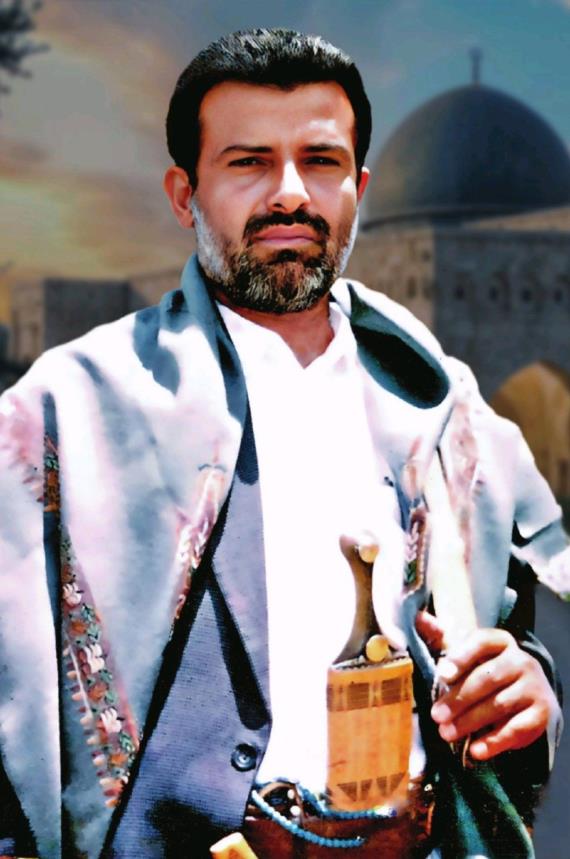يقول السيد حسين - رضوان الله عليه -:
علي عليه السلام الذي كان يأكل ما يتيسَّرُ له، ويَهمُّه أمْرُ الفقراء، وأوصى ولاة أمور المسلمين بأن عليهم أن يقيسوا أنفسهم بفقراء الناس، أن تعيش كما يعيش فقراء الناس، تحاول أن ترفع بالفقراء إلى مستواك، أو تعيش بعيشتهم، لا تَلِي أمرَهم ثم تعيش في ترَف، في قصور فخمة، وممتلكات فخمة والناس الفقراء المساكين هناك يعانون من شظف الحياة وصعوبة الحياة لا يتوفر لهم جزءٌ مما يتوفر لك، قال: «حتى لا يَتَبَيَّغَ بالفقير فَقْرُه»[1]. الفقير يتألم عندما يرى الكبير (ولي أمر) عندما يرى رئيساً، عندما يرى مسؤولاً، أرى أين حياته وأرى أين أنا، أرى أولاده في العيد وأرى أولادي في العيد، أرى زوجتي وهي تتجه إلى أسواق (البَالَة)[2] تشتري ملابس لأولادي في العيد، وهو يُرسِل بنته أو زوجته أو خادم زوجته إلى أرقى معارض عرض الأزياء ليشتري الفساتين الفخمة والأحذية الفخمة. .[3]
الإمام علي عليه السلام في حادثتين مهمتين خلدهما القرآن الكريم وكشف الروحية العالية التي كان يحملها الإمام علي عليه السلام التي لا تختلف عن روحية الأنبياء في حرصهم على الأمة واستعدادهم للتضحية من أجلها واستشعارهم الدائم لمعاناتها»- الحادثة الأولى: }وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ{.
يقول السيد حسين - رضوان الله عليه -:
«عندما دخل مسكين استبدت به الحاجة فطاف على الناس فلم يجد من يسد خلته فأشار إليه علي عليه السلام وهو يصلى في مسجد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله ووهبه خاتـمًا في يده فنزل القرآن على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله مبيّـنًا فضل ما أقدم عليه الإمام علي عليه السلام واستغل القرآن المناسبة لإرشاد الأمة إلى أن عليًّا عليه السلام مرجعها الفكري والعملي بعد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله }إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ{[المائدة:55].[4]
يقول السيد حسين رضوان الله عليه:
لاحظوا، الإمام عليًّا عليه السلام هو آتى الزكاة وهو راكع؟ هل هو يتلفت إلى الفقير ويعرف مَن هو، أو الفقير نفسه يعرف مَن هو هذا؟ أليست هذه هي في حد ذاتها تُبيِّن لنا: أن هذا أحياناً قد يُقدِّم لك خدمة لأنه يعرفك وتعرفه معرفة فيستحي منك أن تعرفه ثم لا يعطيك شيئاً، علي عليه السلام وهو أثناء الركوع ميزة أكثر مِن لو أعطاه وهو أثناء القيام، لو تعرَّض له الفقير وهو أثناء القيام في الصلاة ربما لاتجه الفقير إليه لمعرفة ملامحه ربما يكون لديه شيءٌ، أو ربما رأى الفقير فرأى حالته الرثة فأشفق عليه، لكن لا. هو في حالة الركوع وعادةً يكون الإنسان الذي يركع لا يُبصر إلاّ الأرض، سمع بفقير يسأل، هذا الفقير لا يراه وهو لا يراه فيؤشر بإصبعه إليه ليأخذ خاتمه. هكذا يكون مَن نلحظ فيهم أن تكون نظرتنا إليهم مِن منطلق المعايير الإلهية، التكامل الإلهي مِن خلال ما ترسَّخ في نفوسهم مِن قيم الإسلام ومبادئه، هم مَن سيهتمُّون بمن لا يعرفهم ولا يعرفونه.».[5]
ويقول أيضاً في الدرس الثالث والعشرين من دروس رمضان:
«يقول الله سبحانه وتعالى: }إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ{[المائدة: 55] هذه الآية المباركة المشهور فيها أنها نزلت في الإمام علي (عليه السلام( عندما تصدق بخاتمه وهو راكع بعد أن دخل فقير يسأل ولم يعطه أحد أشار إليه بخاتمه ليأخذه.
قضية الخاتم أليست تبدو قضية بسيطة؟ لكن ماذا يدل عليه هذا العمل؟ يدل على نفسية ثانية، نفسية تهتم بالناس، أليس هذا مؤشرًا مهـمًّا؟ نفسية رحيمة، ونفسية تهتم بالناس، وليس ممن يهتم كيف يأخذ أموال الناس، يهتم بالناس، فأعطاه الخاتم.
والآية هي نفسها تشهد، وتدل على أنها نزلت في قضية خاصة، تأمل الآية نفسها: }يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ{ لا يمكن أن نفسر راكعون بمعنى: مصلون، إذ كيف يمكن يقيمون الصلاة وهم مصلون، ويؤتون الزكاة وهم مصلون، هذا لا يصح في التعبير العادي فضلًا عن القرآن الذي أحكمت آياته، ولم يأت فيما نعرف كلمة: راكعون بمعنى: خاضعون، يأتي بكلمة: ساجد، ساجدين، أو قانتين، هذا الذي نعرفه من خلال القرآن.
فالآية نفسها هي فعلًا تدل على أنها نزلت في قضية، في واقعة خاصة، لشخص خاص، في بداية نزولها، ولا تزال، ولنعرف مثلًا أنه لماذا تأتي مثل هذه الآية في سياق الحديث عن بني إسرائيل! ثم يظهر من خلال الواقع: أن الأمة بحاجة إلى تولي الله ورسوله، وتولي المؤمنين في المقدمة الإمام علي من بعد رسول الله )صلوات الله عليه وعلى آله(.
هذه القضية لا بد منها حتى تهتدي الأمة بالقرآن، وحتى تكون بعيدة جدًّا عن أي محاولة قد تكون بها قريبة من تولي اليهود والنصارى، وحتى تكون بشكل آخر على مستوى عالٍ، تعتبر حزب الله، وحزب الله كما قال: }هُمُ الْغَالِبُونَ{ كما قال بعد في آخر الآية أنهم هم الغالبون؛ لأن ولاية الإمام علي قضية لا بد منها في تحقيق الغلبة والنصر.
وهذا هو ما أشار إليه الإمام الهادي )عليه السلام( فهو يقول إن ولاية الإمام علي )عليه السلام( هي قضية واجبة على المسلمين.. قد تكون القضية مختصة بالإمام علي أساسًا، قد يكون بعده أئمة متأخرون قد لا تكون تعرفهم، قد لا تكون مسؤولًا أمام الله بأنك لماذا لم تعرفهم، وتتولاهم بالتحديد. الإنسان يتولى المؤمنين بشكل عام، بشكل عام يتولى أولياء الله، ويدين الله بولايته لأوليائه، وحبه لأوليائه، لكن الإمام عليًّا هنا يشكل ضمانة، ويشكل نموذجًا لمن بعده، قدم كنموذج لكيف يجب أن تكون ولاية الأمة من بعد رسول الله )صلوات الله عليه وعلى آله (إلى نهاية التاريخ»
ويقول في الدرس الثاني من (آيات من سورة المائدة):
}إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ{
القرآن الكريم في كثير من المواضع يأتي بالكلام عن الصلاة والزكاة وكأنهما نموذج للمجالين الرئيسين في العبادة ـ مثلما يقولون ـ عبادة روحية، وعبادة بدنية مالية. فآية الولاية تبين بجلاء في أمير المؤمنين علي عليه السلام صفة هامة هي العلاقة القوية بالله سبحانه وتعالى سطرها الله سبحانه وتعالى لنا في القرآن وقدمها كصفة مهمة لا بد من توفرها في مَنْ يلي أمر الأمة في قوله تعالى: }الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ{ الصلاة.. أليست خير الأعمال؟. الصلاة فيما تعطيه من آثارها المهمة في العلاقة بالله سبحانه وتعالى وفي ميدان العمل في الحياة كلها، تعتبر فعلًا خير الأعمال لأثرها الكبير، أثرها المهم فيما تحتويه من دلالات مهمة، فيما تعطيه من إشارات مهمة، فيما تترك من آثار مهمة.
الصفة الثانية:
}وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ{ الزكاة: تعني هنا الصدقة. الزكاة في القرآن الكريم تُستعمَل بمعنى الصدقة النافلة، وتستعمَل الصدقة أيضاً بمعنى الزكاة التي أصبحت عَلَماً على النسبة المحدّدة مِن المال المفروضة المرتبطة بعين المال، وإلاّ فكلها تسمى زكاة باعتبار أن الصدقة من حيث هي زكاة للنفوس وزكاة للمال.
}وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ{ أدَّى الزكاة، أي: تصدّق بماله أثناء ركوعه، وتُقدمه بما هو أهم من أن يُذكر باسمه في مقام ترسيخ النظرة إليه كإنسان كامل نرتبط به، وهذا هو ما افتقده السُّنية عندما لم يرتبطوا بعلي عليه السلام لماذا؟ لأنهم اعتبروا أن ذلك الآخر هو أكمل منه، ألم يقولوا بأن أبا بكر أفضل من علي؟ فهم ارتبطوا بمن؟ بأبي بكر بعد أن جعلوه الأفضل، لَمَّا لم ينظروا إلى علي عليه السلام ويلحظوا كماله ويؤمنوا بكماله لم يفدهم اسم (علي) هل أفادهم اسم علي؟ لَمَّا فقدوا الارتباط بعلي باعتبار كماله فقدوا ما كان يُعطيهم الارتباط به، ولم يعد اسمه ينفعُهم، بل جعلوه رابعَهم وقدَّموا عليه أبا بكر، قدَّموا عليه عُمر، قدَّموا عليه عثمان؛ لأنه أصبح (علي، علي، علي) في نفوسهم هكذا. أصبحوا ينظرون إليه (علي، علي) نزلوه المرَّة الأولى، المرَّة الثانية، المرَّة الثالثة، ولولا أن الآخرين حالوا لربما جاء شخْصٌ آخر ونزلوه [لَمَا البادي مِن الخلافة تجي له بأيِّ طريقة][6].
أليس اسم علي معروفاً لدينا ولديهم؟ ما الفارق بيننا وبينهم؟ هو أننا نظرنا إلى علي كرجل كامل، هو أفضل الناس بعد رسول الله (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) هو أكمل الناس بعد رسول الله (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) هو من رباه القرآن ومحمد (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) وكان جديراً بتلقي تلك التربية المهمة، نحن ننظر إليه كإنسان كامل أم أننا فقط نحن الذين عرفنا اسم (علي) والآخرون لم يعرفوا اسم (علي)؟ هم يعرفون اسم (علي) أليسوا يقولون هكذا: أبو بكر، عُمر، عثمان، علي؟ لكن ما الذي جعلنا نختلف عنهم وفَرَق بيننا وبينهم؟ هو أنهم لم ينظروا إلى علي عليه السلام كرجل كامل، كشخص كامل اختاره الله ليكون عَلَماً للأمة بعد نبيه، فمِن هنا يظهر لنا فعلاً أثر النظرة لهذا الشخص الذي ترتبط به باعتبار كماله، أمّا إذا لم تعتبره كاملاً فسيصبح لديك مجرد اسم على جسد، حبر على ورق كما يقولون.
ماذا يوجد في هذا من كمال أيضاً؟ كنت أتصفح كتاباً للسيد محمد حسين فضل الله؛ فجاءت لي فائدة مهمة في هذا الموضوع قال فيها: أنْ يتصدَّق علي بخاتمه وهو يصلي تدلنا على جدارته العظيمة بأن يقود الأمة؛ لأنه هو مَن يهتم بها، مَن يؤلمه فقيرٌ واحدٌ منها فلا ينصرف وهو في مقام التوجُّه نحو الله سبحانه وتعالى، ويقول: ( احنا مصلّين ما هو وقتك) فلا ينصرف بعيداً عن ذلك الفقير، بل تهمُّه قضيتُه، ويُعالج مشكلته كفقير يسأل، فيتصدّق بخاتمه وهو يصلي، هذا هو مَن يهمه أمر الأمة، هذا مَن هو حريصٌ على الأمة ورحيمٌ بها وحريصٌ عليها وشفيق بها، هذا هو الجدير بأن يتزعَّم الأمة ويقودها.
ما أكثر الذين يقولون: (لَسْنا في واديك، نحن في وادي عبادة، هذا أفضل، هذا أحسن)! أليس عليٌّ عليه السلام ممن يقيم الصلاة وهو يصلي؟ لكن وهو يصلي يفهم أن الدِّين أعمالٌ متكاملة وتوجُّهٌ نحو الله سبحانه وتعالى، له علاقته المهمة في نظرتي الحسنة واهتمامي بالآخرين، ومِن أبرز مَن أهتمُّ بهم ويهمُّني أمرُهم: الضعفاء والمساكين وفقراء الأمة، فهو هنا لم يقل: (أنا في عبادة هي خير الأعمال، بعدين، رُحْ لَك). يهمُّه أمرُه، ويقلقه وهو داخل الصلاة لأنه لم يلحظ أن أحداً أعطاه شيئاً؛ فيؤشر له بخاتمه وهو أثناء ركوعه، فيأتي هذا الفقير ويأخذ الخاتم من يده.
لاحظوا كيف قدَّم لنا أعماق علي، ألم يُقدِّم لنا أعماق نفسية الإمام علي عليه السلام بأنه الشخص الذي يهمُّه أمرُ كل شخص في هذه الأمة؟ فكان هذا من أبرز كماله أن يُقدِّم لنا عليًّا باعتباره كاملاً، وهذا هو شيءٌ مما يمشي عليه الناس، وسُنّة يسير عليها الناس حتى في أعمالهم الخاصة، أنت عندما تقول: أريد (معلِّم) يعمل كذا أقول لك: فلان، أليس سيجول في تفكيرك صفاتُ كمال أو عدمها، عنده خِبرة، هو جدير بكذا أو لا؟ أليس هذا الذي سيحصل؟ عندما يقال: جاء محافظ هل سيهمُّني اسمه أم يهمُّني أن أتساءل عن كماله؟ (عسى أن يكون رجلاً جيداً، عسى - إن شاء الله - أن يكون باهراً يهتم بالناس ويعطينا كذا وكذا) أليس يحصل هكذا؟
مدير ناحية، الشيء نفسه، هل يهمك اسمه أو يهمك أن تعرف الكمال الذي هو عليه، ما لديه من مقوِّمات تجعله أهلاً لأن يَلِيَ أمرنا ويدير منطقتنا؟ أليس هذا الذي يحصل؟ يأتي حاكم، الشيء نفسه، أنت في شريعة فيُقال لك: فلان وكّلْه، ما الذي سيطلع في نفسك؟ هل هو جدير بهذه المهمة ولديه خبرة ولديه معرفة، و، و... إلخ؟ أليس هذا الذي يحصل؟ عامل يشتغل في مزرعتك، ما الذي سيحصل؟ يهمُّك اسمُه فقط أم يهمُّك أنه ناصح ويشتغل بجد، وماهر في العمل؟ هذه سُنة من سُنن الحياة إذا فهمناها نحن نعملها، ونحن ننظر إلى الكمال في كل شخص حتى وأنت تبحث لك عن زوجة، أليس كذلك؟ هل يهمُّك اسم الزوجة التي تريد أن تتزوجها فتقول: أريد أن يكون اسمها (مريم) لا يكون اسمها (عَلْوَة) يكون اسمها كذا؟ لا. يهمُّك أن تعرف صفاتها: عسى أن تكون جيدة، عسى أن تكون طبيعتها جيدة، أريد أن تكون كذا، وأن تكون كذا، أليس الإنسان يبحث عن صفات كمال؟ هكذا يرسِّخ الله هذا المبدأ الذي هو مبدأ مهم.
فعندما يربطنا بعلي عليه السلام يربطنا بعلي من باب تقديم علي كرجل كامل جدير بأن نرتبط به، وهو من يصلح أن نتولاه هو الذي هو - إذا كنا ناصحين لأنفسنا - الجدير بأن نتولاه، وأن يكون هو باب مدينة علم الرسول (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) وهو الباب الذي منه ندخل إلى محمد رسول الله (صلى الله عليه وعلى آله وسلم).
يقول لك: لماذا لم يذكر (علي) حتى يكون النص صريحاً؟ هذه هي من سلبيات (أصول الفقه) التي دائماً نصيح منها، من سلبيات أصول الفقه الرهيبة التي تصرفك عن النظر إلى الأشياء من منظار الهداية (أريد أن يقول لي فلان حتى يكون نصاً صريحاً يلزمني) يا أخي القرآن كتاب هداية، الدِّين كله هداية، أعماله كلها هداية حتى عندما ينصب لك محمداً (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) الرسول هو هداية، والقرآن هداية، وعلي هداية، وكل شيء في هذا الكون هو يخاطبك بمنطق الهداية. يريد نصاً صريحاً يأتي باسمه (علي)!
أن يرتبط الناس فقط بمجرَّد اسم تأتي إشكاليات أخرى فينسون الكمال، هو ما ضرَبنا وضرَب أهل السُّنة، وضرَبنا الآن كلنا، أننا لم نعد نلحظ ضرورة أن يكون من يَلي أمرنا رجلاً كاملاً. وعندما ننظر إلى كماله ننظر بالمعيار الدِّيني بالمعيار الإلهي }والَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ{ أليس هذا تقديماً لهم بمقامات دينية وصفات دينية؟ (تَصَدّق) لماذا لم يقل: (والذين آمنوا الذي سيقدِّم لك مشاريع ويعمل لك مشاريع ويعمل لك (إسفلت) ويعمل لك كهرباء ويعمل لك). هل قال هكذا؟
من تتوفر فيه الصفات الدِّينية باعتبار الدِّين هو هدى للناس، من يهمه أمر فقير هو من سيهمه أمر الأمة كلها فيعمل على أن يوفر لها ويؤثرها على نفسه في جميع شؤون حياتها، على يد مثل هذا يتحقق بناء الأمة، تأتي المشاريع، تأتي الخدمات على أرقى ما تكون عليه، والواقع يشهد بهذا؟.
[1] هَذِهِ العِبَارَةُ مِنْ كَلاَمِ الإِمَامِ عَلِيِّ بْنِ أَبي طَالِب عليه السلام وَتَعْني: حَتَّى لاَ يَغْلِبَ الفَقِيرَ فَقْرُهُ وَيَحْمِلُهُ عَلَى الشَّرِّ. شَرْح نَهْج البلاغة 11/237.
[2] أَسْوَاقُ البَالَة: هِيَ التي تَبِيعُ الأَشْيَاءَ المُسْتَعْمَلَة.
[3] سورة المائدة - الدرس الثاني.
[4] ابن كثير في تفسيره ج 3 ص 129، وابن جرير في تفسيره، والخطيب البغدادي في تاريخه ج1 ص 286، والحاكم الحسكاني من عدة طرق، وابن المغازلي في المناقب ص193.
[5] سورة المائدة ـ الدرس الثاني.
[6] البادي ...: هذه العبارة من اللهجة العامية، وتعني: أن حصول الشيء ليس مطلوباً على وجه السرعة بل في أي وقت كان.